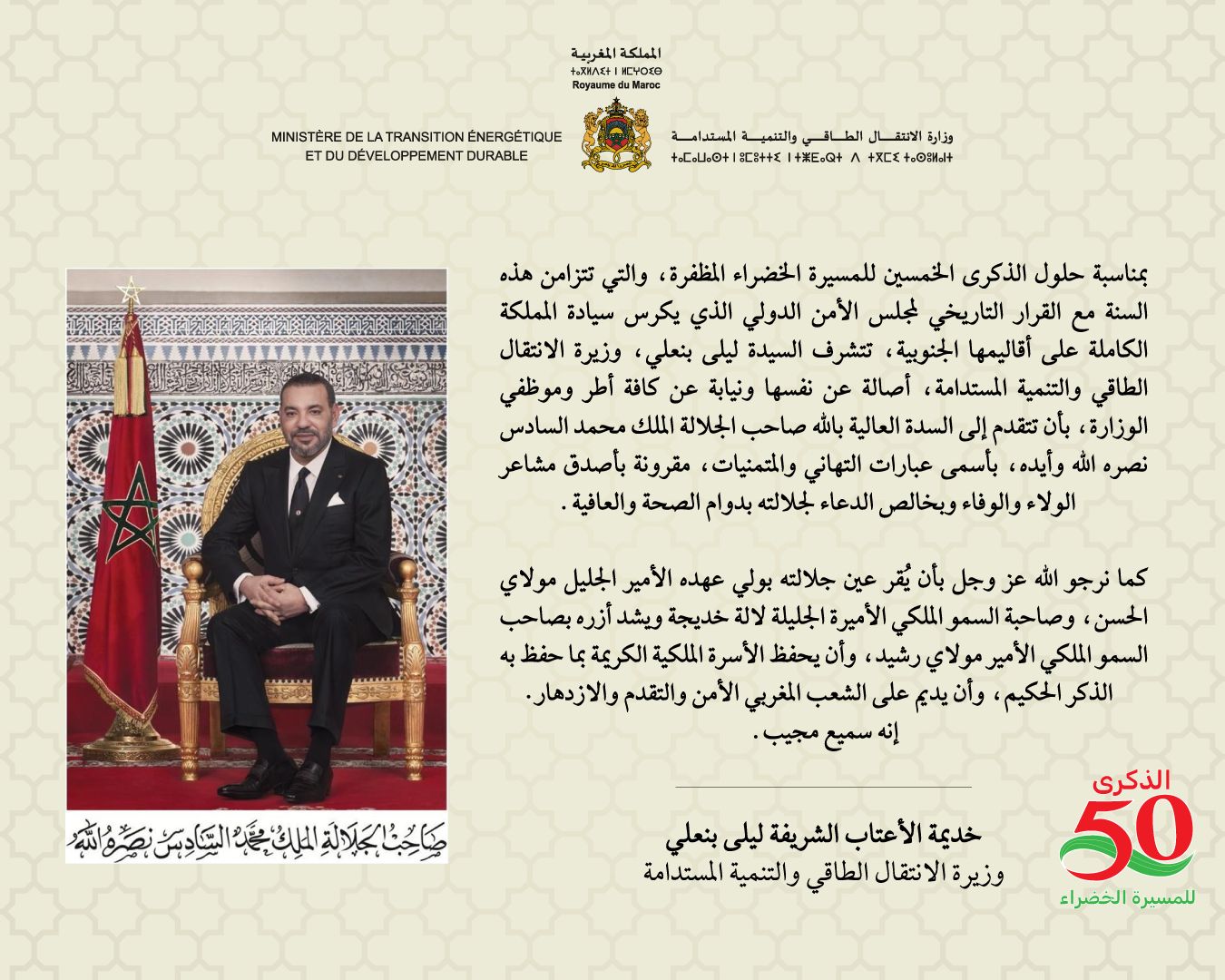الطب في المغرب: بين الهيمنة المهنية ومنطق السوق وتحولات الثقة الاجتماعية

د. هشام بوقشوش / باحث في علم الاجتماع
الجزء الثالث
علاقة الطبيب بالمريض: السلطة، التواصل، والانطباعات يمثل التفاعل الطبي، وفق تصور إرفينغ غوفمان، مساحة اجتماعية تُدار فيها الانطباعات وتُنتَج فيها رموز الثقة والسلطة بشكل أدائي. فالعلاقة بين الطبيب والمريض ليست مجرد علاقة تقنية تنتقل خلالها المعرفة من «خبير» إلى «جاهل»، بل هي علاقة تفاوض رمزي بين طرفين يسعى كل منهما إلى الحفاظ على «وجهه الاجتماعي» وشرعيته داخل سياق محكوم بالضغط الزمني، التوتر النفسي، واللامساواة المعرفية. في هذا المسرح التفاعلي، يظهر الطبيب بصفته حاملًا للمعرفة والشرعية المهنية، فيما يظهر المريض بوصفه ذاتًا مُطالبة بإثبات حاجتها واحترامها للسلطة الطبية.
ضمن هذا السياق، تتجسد ثلاثة أنماط مثالية لهذه العلاقة:
الطبيب كراعي ومعالج:
في هذا النمط، يتبنى الطبيب دورًا أخلاقيًا وإنسانيًا، يقوم على الإنصات النشيط، المشاركة الوجدانية، التفسير الواضح لمسار العلاج، وتقديم الإرشاد الصحي والسلوكي. يعكس هذا التمثل صورة «الطبيب الحكيم» التي تتجذر في الوعي العربي الإسلامي والتقاليد الطبية الكلاسيكية. هنا يتم الاعتراف بالمريض كفاعل اجتماعي كامل، له مخاوفه وتصوراته الخاصة عن المرض، ويُنظر للعلاج باعتباره عملية مشتركة بين معرفة مهنية ومشاعر إنسانية. ينتج عن هذا النمط علاقة تقوم على الثقة، تساهم في تحسين الالتزام العلاجي وتعزز كرامة المريض.
الطبيب كخبير تقني:
يظهر هذا النموذج في سياقات طبية ذات حمولة تقنية عالية، حيث تُختزل التجربة المرضية إلى علامات وأعراض فسيولوجية، وتُعامل الاستشارات كمساحة تشخيصية محضة. هنا يسود ما يسميه فوكو بـ«النظرة الطبية»؛ أي تحويل الجسد إلى موضوع قابِل للقياس والتحليل، بينما تتراجع الذات الإنسانية للمريض خلف الأجهزة والفحوصات. يتخذ الطبيب موقع «المختص الخبير»، فيما يصبح المريض حالة طبية لا حاملًا لمعنى أو تجربة. يؤدي هذا الشكل التفاعلي إلى تقليص التواصل الوجداني وإضعاف الإحساس بالطمأنينة، رغم دقته العلمية.
الطبيب كتاجر خدمات:
يتجلى هذا النموذج خصوصًا داخل القطاع الخاص، حيث تُشرق قيم السوق وتخفت القيم الإنسانية. هنا يُختزل المريض في قدرته على الدفع أو نوع تغطيته الصحية، وتتحول العلاقة إلى معادلة تبادلية صريحة: خدمة مقابل مقابل مالي. تكاد تختفي الرمزية الأخلاقية ويحل محلها منطق المؤسسة الربحية. يشعر بعض المرضى في هذا الإطار بأن أجسادهم ومخاوفهم أصبحت «سلعة للعلاج»، وبأن زمن الاستشارة وجودتها يتحددان وفق القدرة الاقتصادية لا وفق الحاجة العلاجية. تتولد هنا مشاعر الضيق، واللاعدالة، والتشييء.
في خلفية هذه الأشكال التفاعلية، تعمل دينامية «العنف الرمزي» كما يصفها بورديو؛ إذ يُقبل المريض التعليمات الطبية دون قدرة حقيقية على النقاش أو الفهم المعمّق، نتيجة الفجوة المعرفية والهيبة المهنية التي تمنح للطبيب سلطة تأويل الجسد والألم. يؤدي هذا الوضع إلى شعور بالاغتراب الطبي، حيث يفقد الفرد السيطرة على معنى مرضه ومسار علاجه، ويتحول إلى متلقٍ سلبي لقرارات تُصاغ بلغة تقنية مغلقة. ضمن هذه الوضعية، يظهر المرض لا كحدث بيولوجي فقط، بل كخبرة اجتماعية يعيش فيها المريض انعدام التوازن بين المعرفة والسلطة، وبين الضعف الجسدي والهيمنة الرمزية.
بهذا التحليل، تُفهم العلاقة الطبية في المغرب—وفي السياقات العربية عمومًا—بوصفها ساحة تتقاطع فيها الأخلاق، السوق، السلطة العلمية، والحاجة الإنسانية للأمان. لا يكتمل علاج الجسد إلا بتضميد هشاشة المريض الاجتماعية والرمزية، ولا تستعاد الثقة إلا بإعادة الاعتبار للعلاقة الإنسانية التي تشكّل جوهر الممارسة الطبية قبل أن يتحول الطب إلى صناعة قائمة على الاستهلاك والمعايير الكمية.